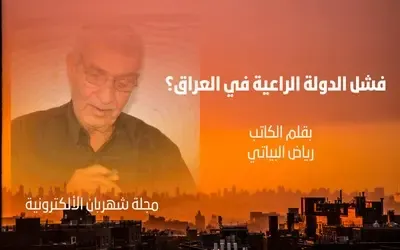🔶 جذور مفهوم الدولة الراعية في العراق
🔸 ما هي الدولة الراعية؟ لنفهم فشل الدولة الراعية في العراق، لا بد أن نعود أولاً إلى أصل هذا المفهوم. الدولة الراعية، كما وُلدت في الفكر السياسي الغربي، هي تلك التي تتكفل برعاية المواطنين من المهد إلى اللحد. يُفترض بها أن تؤمن لهم خدمات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، وتُعيد توزيع الثروات بعدالة.

|
| جذور مفهوم الدولة الراعية في العراق |
تطورت هذه الفكرة خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية، في الدول الأوروبية، كردّ فعل على فظائع الحرب والاضطرابات الاقتصادية. كانت النية نبيلة: الدولة ستكون "الأب الحنون" الذي لا يترك أبناءه يتضورون جوعاً أو يمرضون دون دواء.
لكن هذه الصورة الجميلة بدأت تتآكل تدريجياً مع دخول العالم في عولمة اقتصادية شرسة. لم تعد الدولة تستطيع أن تفي بجميع التزاماتها، فتراجعت الخدمات، وبدأت الشركات الخاصة تسد الفجوة، بل تتجاوز الدولة في القوة أحيانًا. عندما ضربت جائحة كورونا العالم، لم تكن الحكومات وحدها من تصدّت للأزمة؛ بل شركات الأدوية والتقنية – من فايزر إلى مايكروسوفت – كانت على الخط الأول.
إذًا، الدولة الراعية الحديثة تحولت إلى شريك أكثر منها وصيًّا. لم تعد تأمر بل تُنسّق، ولم تعد تُلزم بل تُحفّز. ولعل هذا هو التحوّل الذي لم يحدث في العراق: الدولة لا تزال تريد أن تبقى "الأب"، ولكن دون أدوات هذا الأب، ولا صدقه.
🔸 النسخة العراقية من الدولة الراعية
في العراق، لم تكن الدولة الراعية يوماً مؤسسة ذات وظائف مدروسة أو هيكلية حديثة، بل كانت أقرب إلى امتداد لعقلية "ولاية الأمر". هنا، الدولة لا ترعى بل توجّه، تأمر، تُعاقب، وتمنّ على المواطن كأنها تتفضل عليه بما هو حقه الطبيعي.
والغريب أن النخب التي صعدت إلى السلطة، خصوصًا بعد الاحتلال الأمريكي، لم تحاول أن تُقنعنا أنها تمتلك برنامجًا فكريًا أو مشروعًا حضاريًا. لم يظهر حزب لديه رؤية اقتصادية واضحة، أو برنامج للإصلاح الإداري. الكل قدّم نفسه بعباءة العشيرة أو صكّ ديني. كأن الوطن لا يحتاج عقولًا بل أنسابًا. وكل فشل يُغلف برداء الطائفة أو يُبرَّر باسم "المظلومية" أو "الإرث التاريخي".
الدولة الراعية في العراق لا تستمد مشروعيتها من كفاءة أو إنجاز، بل من مصادر عرفية مثل "النسب"، أو منطق "احنا أولى بيها". وبالتالي، لا يُسائلها أحد عن الفشل، ولا تُحاسب على التغاضي عن الفساد، لأن الأمر في جوهره ليس دولةً بقدر ما هو منظومة عرفية تحكم مجتمعًا مفككًا.
وهنا نرى الفرق الجوهري: بينما تنتقل دول العالم من الرعاية الأبوية إلى المشاركة المجتمعية، لا تزال الدولة العراقية تتمسك بنموذج وصاية قديم، دون أي أدوات للرعاية الفعلية. فهي لا تنتج، لا توزع بعدالة، ولا تصنع قيادات قادرة على إدارة التغيير.
🔶 لماذا فشلت الدولة الراعية في العراق؟
الدولة الراعية في العراق تثبت فشل مشروعها ولطالما تحاول النخب المقربة من مصادر القوة ان تقدم نفسها بصورة أبوية لرعاية الدولة. تقدم نفسها ان لها نَسبا دينيا! او تاريخا قبليا .لم يقدم أحداً نفسه صاحب فكر أو أيديولوجيه. كان ذلك واضحا لدى النخب السياسية التي جاءت مع المحتل. او تشكلت في الداخل. بعد الاحتلال.
🔸 النخب السياسية ودورها السلبي
إن أردنا الحديث عن فشل الدولة الراعية في العراق، فلا يمكننا تجاهل الدور المحوري الذي لعبته النخب السياسية في هذا الفشل. هذه النخب التي برزت بعد 2003، سواء ممن عادوا مع الاحتلال الأمريكي أو من صعدوا من داخل البلاد، لم تكن مؤهلة لبناء مشروع وطني جامع. بل جاءت وفي جعبتها أجندات فئوية ضيقة، وقصص مستهلكة عن "مظلومية الطائفة" و"استعادة الحقوق"، دون أي محاولة جادة لبناء دولة مؤسسات.
هذه النخب لم تقدّم مشروعًا، بل قدّمت شخوصًا. لم نسمع يوماً عن خطة استراتيجية لعشر سنوات قادمة، أو عن رؤية لتطوير الاقتصاد الوطني، أو إعادة هيكلة النظام التعليمي. جلّ ما رأيناه هو تقسيم للكعكة، ومحاصصة، وتنافس على المناصب لا على الخدمة. والأدهى أن هؤلاء السياسيين يتسترون خلف عباءات الدين والعشيرة، وكأن الشعب لا يستحق قادة يفكرون، بل فقط من "ينتمون" للقبيلة أو الطائفة.
أضف إلى ذلك أن النخب كانت دائماً على علاقة مباشرة مع مراكز القوة الدولية والإقليمية، وأحيانًا تعمل كوكيل لهذه القوى. فكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يُنتجوا دولة راعية حقيقية؟ كيف يمكنهم أن يُراعوا مصالح الشعب وهم مرتبطون بمصالح خارجية؟
إن فشل الدولة الراعية ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لتركيبة سياسية مشوهة ونخب غير وطنية. وهذا ما يجعل الحاجة ملحة لبناء بديل يبدأ من القاعدة الشعبية، لا من القمم المشغولة بالمصالح الشخصية.
🔸 غياب العدالة في توزيع الثروات
العراق، بلدٌ غني إلى حد الترف، لكنه يعيش في فقر مدقع. يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنه يفتقر إلى الكهرباء والماء والخدمات الأساسية. هذه المفارقة الفاضحة لا يمكن تفسيرها إلا بفشل الدولة الراعية في أداء دورها في توزيع الثروات.
وظيفة الدولة الراعية الأساسية هي توزيع الموارد بعدالة، وضمان أن تصل عائدات الدولة إلى المواطن، لا إلى جيوب الفاسدين. لكن في العراق، تحولت الثروة إلى لعنة، إلى سببٍ إضافي للصراع، لا أداة للتنمية. القوى السياسية تتنازع ليس من أجل تقديم الأفضل للمواطن، بل من أجل حصة في الريع النفطي. الوزارات تُشترى وتُباع كما تُباع البضائع في السوق.
لا يوجد أي نظام اقتصادي حقيقي. لا إنتاج زراعي قوي، ولا صناعة وطنية، ولا حتى استثمار في الإنسان. كل ما في الأمر أن الدولة تجمع الأموال من النفط، ثم توزعها عبر نظام محاصصة طائفية يضمن استمرار الولاء للسلطة وليس للوطن. وهكذا، تُقتل أي إمكانية لنشوء طبقة وسطى منتجة، ويُقضى على الحلم بأن يتحول العراق إلى دولة حديثة. المواطن يُهمّش، والفساد يُكافأ، والدولة تُدار كأنها غنيمة، لا مسؤولية.
🔶 مقارنة مع نماذج عالمية
لعقد المقارنة بين النماذج العالمية لنماذج الدول الراعية والتطورات التي حدثت من اجل خدمة المجتمع في تنظيم الامور في حالة الطوارئ واليكم تطورات الدولة الراعية.
🔸 الدولة الراعية في الغرب
إذا ما نظرنا إلى الغرب، وخصوصًا أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، سنلاحظ أن الدولة الراعية هناك قد تطورت مع تطور المجتمعات نفسها. لم تبقَ الدولة مجرد إطار قانوني أو مؤسسة تقليدية، بل أصبحت نظامًا ديناميكيًا يستجيب لحاجات الأفراد ويتفاعل مع الأزمات بشكل مباشر ومرن. فحينما اجتاحت جائحة كورونا العالم، لم يكن تدخل الدولة مجرد خيار بل كان ضرورة مصيرية. استُنفِرت كل موارد الدولة لحماية الصحة العامة ودعم الاقتصاد، ولكن لم تكن الدولة وحدها في هذه المعركة.
دخلت شركات التكنولوجيا والأدوية على الخط، مثل "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، لتثبت أن الحلول الحديثة تأتي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد حدث هذا بسرعة غير مسبوقة، وهو ما لم تكن الدول قادرة على فعله لوحدها. وهنا يظهر تحول جوهري في طبيعة الدولة الراعية: لم تعد تلعب دور المهيمن أو الوصيّ، بل أصبحت لاعبًا أساسيًا ضمن منظومة أكبر.
حتى المؤسسات الاجتماعية في الغرب أصبحت أكثر استقلالًا، تراقب أداء الدولة، وتدفعها إلى الشفافية. المواطن في هذه الدول ليس مجرد متلقي بل شريك فعال، وهذا ما جعل من فشل الدولة هناك في بعض الجوانب مؤقتًا، لا هيكليًا. الفشل يُعالج، لا يُعمم. بينما في العراق، الفشل هو البنية نفسها.
🔸 هل فشلت الدولة الراعية عالمياً؟
رغم النجاحات المؤقتة للدول الراعية في الغرب، إلا أن هذا النموذج بدأ يُواجه تحديات ضخمة. لم يعد النموذج الكلاسيكي قابلاً للتطبيق في ظل عالم تتحكم به الشركات الكبرى، وتُصاغ قراراته من منصات التواصل الاجتماعي لا من قصور الحكام. انخفضت ثقة الشعوب بالحكومات، وبرزت مطالب جديدة تتجاوز ما تقدمه الدولة الراعية التقليدية.
في الولايات المتحدة مثلاً، شهدنا كيف فشلت الدولة في البداية بالسيطرة على جائحة كورونا، واضطرت للاعتماد على القطاع الخاص لتوفير اللقاحات. لم تعد الحكومة هي المنقذ الوحيد، بل أصبحت المنصة، الإطار، والبيئة التي تسمح للابتكار بأن يُثمر. وهنا يتبيّن أن الدولة الراعية في نسختها الحديثة لم تعد مركز القوة الوحيد، بل أصبحت شريكًا في القوة، وأحيانًا تابعًا لها.
ما يحدث اليوم في العالم ليس مجرد أزمة حكومات، بل أزمة نماذج سياسية بالكامل. الشركات التقنية مثل "أبل" و"أمازون" و"فيسبوك" أصبحت تصنع الرأي العام، وتؤثر على الانتخابات، بل وتفرض سياسات خصوصية وسيادة رقمية تفوق قدرة الدول على التحكم.
إذًا نعم، يمكن القول إن الدولة الراعية فشلت عالميًا، لكن الفرق هو أن فشلها في الغرب أدّى إلى التفكير بإصلاحات جذرية، أما في العراق، فالفشل أصبح هو النظام السائد، دون أدنى محاولة للتغيير أو التقييم.
🔶 الحلول الممكنة من داخل المجتمع العراقي
هل توجد حلول من الممكن اسبخدامها في عملية التغيير من عدة جوانب أولها النهوض بالمجتمعات المحلية والمشاركة في المشاريع والتعاونيات وهي تعد من أذكى التطور الاقتصادي للمجتمع واليكم شرحها:
🔸 النهوض بالمجتمعات المحلية
إذا كانت الدولة المركزية قد فشلت في أداء دورها، فلماذا لا نعود إلى المجتمعات المحلية؟ هذا السؤال ليس تنظيرًا أكاديميًا، بل ضرورة واقعية. النموذج الذي أثبت نجاحه في بعض مناطق شمال العراق يمكن أن يُحتذى به في أماكن أخرى، لا سيما في الجنوب حيث الإمكانيات الاقتصادية والبشرية هائلة.
المجتمع البابلي، كمثال، يمتلك المال والخبرة الفنية، لكنه ما زال ينتظر "الدولة" لتبدأ. في الواقع، الدولة لن تبدأ، وإن بدأت فلن تُنهي. الطريق الصحيح هو أن تبادر المجتمعات المحلية إلى إنشاء مشاريع إنتاجية، تبدأ من المحطات الكهربائية الصغيرة، وتنتهي بشركات مساهمة تُعيد تعريف الاقتصاد المحلي.
لماذا لا نرى في الحلة أو الناصرية أو العمارة شركة محلية للطاقة، مملوكة من أبناء المدينة؟ لماذا لا يتم استثمار العقول العراقية في الخارج في توجيه هذا التغيير؟ الفكرة بسيطة، لكنها تحتاج إلى إرادة. المجتمعات يمكنها أن تتقدم حينما تتجاوز انتظار الحلول من "فوق"، وتبدأ بتكوين سلطتها الإنتاجية من "تحت".
ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى قادة مجتمعيين لا يسعون إلى المناصب بل إلى التغيير، وإلى جمهور مستعد أن يتحول من متلقٍ إلى مساهم، من متفرج إلى فاعل.
🔸 التعاونيات والمشاريع المجتمعية
من أذكى الأدوات الاقتصادية التي يمكن أن تُحرّك المجتمعات الراكدة هي التعاونيات الاقتصادية. التعاونيات ليست فقط نموذجًا اقتصاديًا، بل هي أداة سياسية لتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل. في العراق، ورغم كل هذا الغنى، لا نجد ثقافة تعاونية راسخة، بينما دول فقيرة مثل الهند أو كينيا استطاعت أن تُنتج نماذج تعاونية ناجحة.
فكرة شركة مساهمة محلية لإنتاج الطاقة في مدينة مثل بابل ليست خيالًا، بل مشروع عملي. تُجمع الأموال من الأهالي، يُختار مجلس إدارة من داخل المجتمع، تُوظّف الكفاءات المحلية، ويبدأ العمل. الأرباح تُوزع بعدالة، ويتم reinvestment في مشاريع جديدة. وبهذا الشكل، يُعاد بناء الاقتصاد من القاعدة، وتُخلق قوى سياسية جديدة ليست لها صلة بالحرس القديم من السياسيين.
إن غياب الدولة المركزية لا يجب أن يكون سببًا في التراجع، بل دافعًا للابتكار. الدولة الفاشلة تترك فراغًا، لكن المجتمعات الذكية تملأ هذا الفراغ ببدائلها، بشرط أن تمتلك الثقة والخيال والإرادة.
🔶 الإرادة الاقتصادية كمدخل للتغيير السياسي
أن عوامل التغيير السياسي لتكوين جذور الدولة الراعية ومن خلال أتخاذ عدة عوامل التي تكون البناء الصحيح ، والاعتماد على أدارة الاقتصاد, وتجديد الدماء في بناع قاعدة رصينة للربط بين الاقتصاد والسياسية.
🔸 لماذا الاقتصاد أولاً؟
الاقتصاد ليس مجرد أرقام في الميزانية أو صادرات وواردات. إنه المحرك الأول لأي تغيير سياسي حقيقي. في العراق، تعثّرت جميع محاولات الإصلاح السياسي لأنها لم تُبنَ على قاعدة اقتصادية راسخة. كيف يمكن لمجتمع أن ينتخب بحرية وهو جائع؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطن أن يكون واعيًا سياسيًا، بينما لا يجد وظيفة أو تعليمًا جيدًا أو رعاية صحية؟
السلطة السياسية في العراق اليوم تُبنى على التحكم بالاقتصاد الريعي. كل حزب يريد وزارة من الوزارات السيادية، لا لأنه يريد خدمة الشعب، بل لأنها صندوق مالي مفتوح يمكن أن يُموِّل حملاته، ويوزِّع الوظائف على أنصاره، ويُحكم قبضته على المجتمع. إذًا، من يمسك بالاقتصاد يملك السياسة.
لهذا، فإن أي محاولة للتغيير السياسي لا يمكن أن تُثمر إذا لم تبدأ من إصلاح اقتصادي حقيقي، يقوده المجتمع نفسه. والمقصود بالإصلاح هنا ليس مجرد تقليل الإنفاق الحكومي أو مكافحة الفساد – رغم أهمية ذلك – بل المقصود هو تمكين المواطن من أن يكون منتجًا، لا تابعًا. أن يكون له مشروع، لا مجرد وظيفة. أن يكون له دخل مستقل، لا راتب من حكومة فاشلة.
حينما يمتلك المواطن العراقي شركة صغيرة، أو يدخل في تعاونية، أو يساهم في شركة مساهمة محلية، فإنه يخرج من دائرة السيطرة التقليدية. يصبح حُرًّا في قراره، ويبدأ تدريجياً في التأثير في السياسة المحلية. من هنا تبدأ الديمقراطية الحقيقية.
🔸 ولادة قيادة جديدة من القاعدة
التحول الاقتصادي المحلي لا يخلق فرص عمل فقط، بل يخلق قادة حقيقيين. في كل تجربة اجتماعية ناجحة، وُجد قادة ميدانيون ومنظرون تحمّلوا المسؤولية، واجهوا النقد، وتعرضوا للتجريح، لكنهم صمدوا حتى وصلوا بالمجتمع إلى برّ الأمان. العراق لا يفتقر إلى القادة، بل يفتقر إلى المناخ الذي يُفرزهم.
القيادة في العراق، لسنوات طويلة، كانت محصورة بين من يملكون المال والسلاح والدعم الخارجي. لكن في ظل الفشل المتكرر لهذه الطبقة، هناك فرصة ذهبية لنشوء جيل جديد من القادة، قادة من القاعدة الشعبية، من الورش والمزارع والشركات الناشئة، من العمل الجماعي، لا من المكاتب السياسية.
هؤلاء القادة لا يحتاجون إلى خلفيات دينية أو عشائرية ليثبتوا جدارتهم. يكفي أن يكون لديهم مشروع، وأن يُثبتوا أنهم قادرون على تنفيذ ما يقولونه. والأهم، أن يكون لديهم الاستعداد للاستماع، وتقبّل النقد، والعمل بروح الفريق.
المجتمع العراقي اليوم بحاجة إلى أن يفرز هذه القيادات. يحتاج إلى إعلام جديد يُسلّط الضوء على النماذج الناجحة، لا فقط على الفاسدين. يحتاج إلى مدارس وجامعات تُخرّج رواد أعمال، لا مجرد موظفين بانتظار التعيين. وبحاجة، قبل كل شيء، إلى ثقة جديدة: ثقة بأن التغيير ممكن، وأن القيادات الحقيقية تبدأ من الناس، لا من فوق رؤوسهم.
🔶 الخاتمة: العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من أزمة إدارة، وأزمة ثقة، وأزمة وعي سياسي واجتماعي. الدولة الراعية، بمفهومها الحالي، أثبتت فشلها الذريع، ليس فقط لأنها عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين، بل لأنها أصبحت أداة لسلب حقوقهم والتحكم بمصيرهم.
التحول المنشود لن يأتي من الانتخابات فقط، ولا من تدوير نفس الوجوه. بل سيأتي حينما يبدأ المجتمع المحلي في بناء قوته الاقتصادية، وينتج قياداته من قاعدته لا من رأس الهرم. عندها فقط، يمكن أن يُعاد تعريف الدولة لا كراعية شكلية، بل كشريك فاعل في التنمية.
الخطوة الأولى قد تكون صعبة، لكن الطريق واضح. والقادة الحقيقيون لا ينتظرون الظروف، بل يصنعونها.